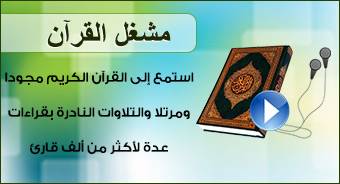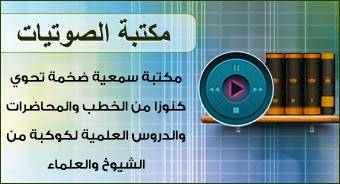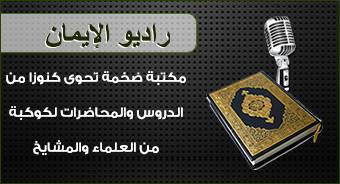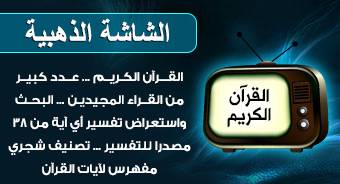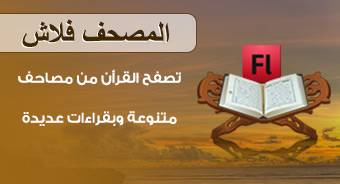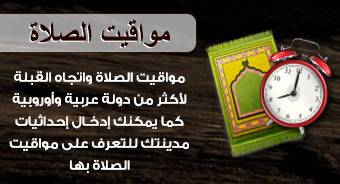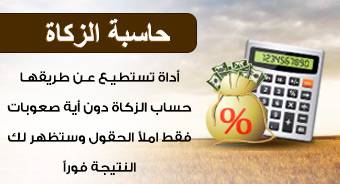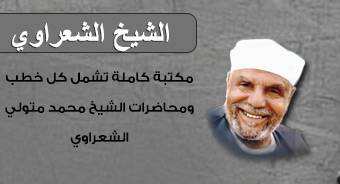|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وعرفا: ما يلبس في الرّجل من جلد رقيق، الجمع: أخفاف، وخفاف. وتخفف خفّا: لبسها، وفي المثل: (رجع بخفي حنين). وشرعا: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض مانع للماء يمكن متابعة المشي فيه. [المعجم الوسيط (خفف) 1/ 256، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 393، والتوقيف ص 320].
والأخفية: الأكسية، والواحد: خفاء، لأنها تلقى على السّقاء. قال الكميت يذم قوما وأنهم لا يبرحون بيوتهم ولا يحضرون الحرب: وفي حديث أبى ذرّ رضي الله عنه: «سقطت كأني خفاء». [النهاية 2/ 57] الخفاء: الكساء، وكل شيء غطيت به شيئا فهو: خفاء. والخفاء: الثوب الذي يتغطى به. [معجم الملابس في لسان العرب ص 55].
حميته وأجرته من طالبه، وخفر بالرجل: إذا غدر به. والخفارة- بكسر الخاء-: الإجارة، ويقال- بالضم-: وهو ما يعطى الخفير على خفارته. [المغني لابن باطيش ص 260، والموسوعة الفقهية 28/ 316].
[المطلع ص 38].
- تحريك الرأس عند النعاس.- خفق: سقط. وفي الحديث عند أبى داود عن أنس رضي الله عنه: (كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم، ثمَّ يصلون ولا يتوضئون) [أحمد 3/ 239] معناه: تسقط أذقانهم على صدورهم. قال ذو الرّمّة: كذا في (الديوان). وفي رواية: الخفقة: كالسّنة من النوم، وأصله ميل الرأس. [الكليات ص 414، ونيل الأوطار 1/ 193، ومعالم السنن 1/ 62، وفتح الباري (مقدمة) ص 118، وديوان ذو الرمة ص 579، ط. كمبردج].
وهو ما كان خفاؤه في انطباقه على بعض أفراده لعارض هو نسبة ذلك الفرد باسم آخر. [ميزان الأصول ص 353، والحدود الأنيقة ص 80، والموجز في أصول الفقه ص 130، وتيسير التحرير 1/ 156، وكشف الأسرار 1/ 152، والموسوعة الفقهية 1/ 51، 29/ 154].
والخلاء ممدودا: المكان الذي تقضى فيه الحاجة، عن الجوهري. وأصله من الخلوة، لأن من يريد قضاء الحاجة فإنما يكون وحده ليخلو بنفسه، فسمى ذلك الموضع خاصة بذلك. وقال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاء، والمذهب، والمرفق، والمرحاض، ويقال له أيضا: الكنيف، للاستتار فيه، وكل ما ستر من بناء وغيره فهو كنيف. والخلاء: البعد المفطور عند أفلاطون. والخلاء: الفضاء الموهوم عند المتكلمين، أي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء والهواء في داخل الكوز، فهذا الفراغ الموهوم هو الشيء الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفا له عندهم، وبهذا الاعتبار يجعلونه حيّزا، للجسم، وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يجعلونه خلاء. والخلاء ممتنع عند الحكماء دون المتكلمين. [المطلع ص 11، 230، والكفاية للخوارزمي 1/ 366، 367، والمغني لابن باطيش ص 47].
ومنه: (السحاب الخلب): الذي لا مطر فيه. والخداع: إظهار ما في النفس، وإخفاء الغش، من خدعت عين الشمس: إذا غابت، وقيل: معناه الفساد، كما قال: طيب الريق إذا الريق خدع أي: فسد، كأنه يفسد ما يظهره من النصيحة بما يخفيه من الغش. [النظم المستعذب 1/ 236، والمغني لابن باطيش ص 311، 312].
قال الشاعر: فائدة: التفريق بين (الاختلاف)، و(الخلاف): بأن الأول يستعمل في قول بنى على دليل، والثاني فيما لا دليل عليه. وأيده التهانوى بأن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له: (خلاف) لا (اختلاف)، قال: والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في (الخلاف) كمخالفة الإجماع، وعدم ضعف جانبه في الاختلاف، وقد وقع في كلام بعض الأصوليين والفقهاء عدم اعتبار هذا الفرق، بل يستعملون- أحيانا- اللفظين بمعنى واحد، فكل أمرين خالف أحدهما الآخر خلافا، فقد اختلفا اختلافا، وقد يقال: إن الخلاف أعم مطلقا من الاختلاف، وينفرد الخلاف في مخالفة الإجماع ونحوه. ويستعمل الفقهاء (التنازع) أحيانا بمعنى: الاختلاف. خلاف الأولى: كأكل ميتة، وقصر بشرط وسلم، وفطر مسافر لا يضره الصوم. [النظم المستعذب 2/ 35، ولب الأصول على جمع الجوامع ص 18، والموسوعة الفقهية 2/ 293].
- النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا استخلف الله عباده في الأرض. وفي الاصطلاح الشرعي: منصب الخليفة: وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا: الإمامة الكبرى، فهي ترادف الإمامة. وقد عرّفها ابن خلدون بقوله: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، ثمَّ فسر هذا التعريف بقوله: فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا. [نهاية المحتاج 7/ 409، وحاشية ابن عابدين 1/ 368، ومقدمة ابن خلدون ص 190، والكليات ص 407].
[القاموس القويم للقرآن الكريم ص 208].
وأخلت النخلة: أطلعت الخلاء. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1144].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 55، والمطلع ص 177].
الأول: خلطة أعيان: وهي ما إذا كان الاشتراك في الأعيان. الثاني: خلطة أوصاف: وهي أن يكون مال كل واحد من الخليطين متميزا فخلطاه واشتركا في عدد من الأوصاف كالمراح المأوى والمرعى والمشرب والمحلب والفحل والراعي. - وللخلطة أثر عند بعض الفقهاء في اكتمال نصاب الأنعام واحتساب الزكاة، وتفصيله في (الزكاة). - والخلطة: حالة ترفع بعد توجّه الدّعوى على المدعى عليه. أو هي: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على ملك واحد. [شرح حدود ابن عرفة 1/ 146، 612، والموسوعة الفقهية 4/ 319].
في اللغة: القلع، والإزالة والنزع والإبانة، من خلع الرجل ثوبه: أي نزعه وأزاله، ومنه قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [سورة طه: الآية 12]. ومنه: (خلع الخلافة): إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها، ومنه: (خلع الرجل امرأته وخالعها): إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كلّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال الله تعالى: {هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ} [سورة البقرة: الآية 187] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. والخلع- بالفتح-: الإخراج كقولك: (خلعت القميص عن بدني، وخلعت الخاتم من إصبعي)، كأن المرأة ثابتة بالنكاح، فإذا طلّقت فقد خلعت وشرعا: - قال صاحب (الاختيار): إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، وقال: وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا، لزمها المال، ووقعت تطليقة بائنة. - قال في (الفتاوى الهندية): إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، كذا في (فتح القدير). - قال الأحمدنكري: الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع، والواقع به الطلاق البائن، فإذا قال: (خالعتك) يقع الطلاق البائن. - وقال الشوكاني: فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. - وقال صاحب (مختصر خليل): هو الطلاق بعوض. - وقال ابن رشد: اسم الخلع، والفدية، والصلح، والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقاط حقّ لها عليه. - وقال في (الكواكب): هو الطلاق بعوض أو بلفظ الخلع. - وقال في (الإقناع): فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. - وقال البهوتي: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. فوائد: وقد ذهب الحنفية في المفتي به، والمالكية، والشافعية في الجديد، والحنابلة في رواية إلى أن الخلع: طلاق. وذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى: أنه فسخ.- وذكر أبو بكر بن دريد في (أماليه): أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظّرب- بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء الموحدة-: زوج ابنته لابن أخيه عامر بن الحارث بن الظّرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكى إلى أبيها فقال: (لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها). قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. [اللسان (خلع) 2/ 1232، ومختصر خليل ص 119، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 82، والفتاوى الهندية 1/ 488، والاختيار 3/ 120، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 183، والإقناع 3/ 64، والروض المربع ص 408، والمغني لابن باطيش ص 515، ودستور العلماء 2/ 93، ونيل الأوطار 6/ 247، والتوقيف ص 324، والنظم المستعذب 2/ 157، والكواكب الدرية 2/ 217، والموسوعة الفقهية 29/ 6]. |