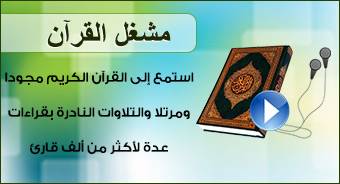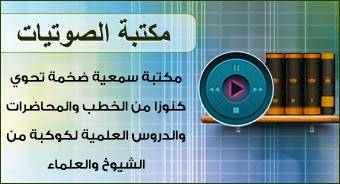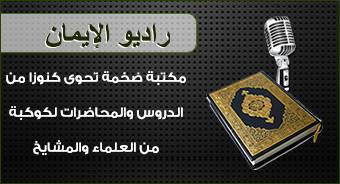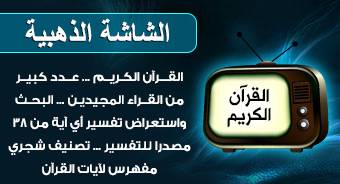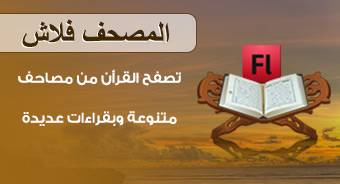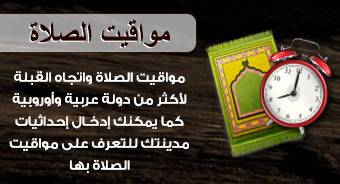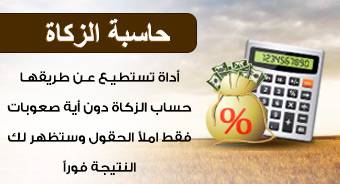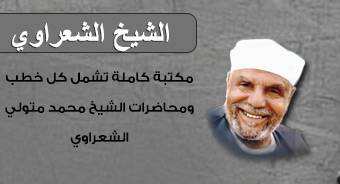|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والظلم أعم من الفسق. وقال أبو البقاء: الفسق: الترك لأمر الله، والعصيان والخروج عن طريق الحق والفجور. [المعجم الوسيط (فسق) 2/ 714، وغريب الحديث للخطابي 1/ 603، والكليات ص 692، 693، والنهاية 3/ 446].
[تحرير التنبيه ص 359].
- وما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. - والفلقة من فلق الليمون والبرتقال ونحوهما. [المعجم الوسيط (فصص) 2/ 116، والكليات ص 675].
[المعجم الوسيط (فصح) 2/ 716، وغريب الحديث للبستي 1/ 169].
[النهاية 3/ 451، والمصباح المنير (فصص) ص 474].
[المصباح المنير (فصل) ص 474، والمعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، والمطلع ص 7، والنهاية 3/ 451].
[المصباح المنير (فصل) ص 474، والمطلع ص 283].
[المصباح المنير (فض) ص 475، والمغرب ص 361].
وحكمه: يثاب فاعله، ولا يأثم تاركه. [النهاية 3/ 455، والكليات ص 675، والتوقيف ص 559، والتعريفات ص 146].
- ابتداء إحسان بلا علة. - قال الراغب: الزيادة على الاقتصاد، ومنه محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون، وهو من المحمود أكثر استعمالا، والفضول: في المذموم. [الكليات ص 675، والتعريفات 146، والنهاية 3/ 455، والتوقيف ص 559].
[المصباح المنير (فض) ص 475، والمطلع ص 9].
- اشتغال المرء أو تدخله فيما لا يعنيه. - عند الأطباء: ما يخرج من البدن بدون معالجة. - حلف الفضول: حلف بين قبائل من قريش تعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهلها ممن دخلها إلا نصروه حتى تردّ مظلمته، وقد شهده رسول الله صلّى الله عليه وسلم، في دار عبد الله ابن جدعان. قال ابن الأثير: قام به رجال من جرهم كلهم يسمى الفضل، منهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل ابن فضالة. [المعجم الوسيط 2/ 717، والنهاية 3/ 456].
وهو من الفضول، جمع: فضل، وقد استعمل الجمع استعمال الفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب على لفظه، فقيل: فضولي. واصطلاحا: من لم يكن وليّا ولا وصيّا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. [المعجم الوسيط 2/ 719، والتعريفات ص 146، والتوقيف ص 559].
وهو أن يجعل التمر في إناء، ثمَّ يصب عليه الماء الحار فيستخرج حلاوته، ثمَّ يغلي ويشتد فهو كالباذق في أحكامه، فإن طبخ أدنى طبخة فهو كالمثلث. [المغرب ص 361، والمصباح المنير (فضخ) ص 475، والتعريفات ص 146].
وعند الفقهاء: ترادف المندوب، والنافلة، وهي ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم فيؤجر على فعله، ولا يأثم بتركه ويكون مخالفا للأولى. [نيل الأوطار 2/ 54 (واضعه)].
والفطرة- بالكسر-: الخلقة، قاله الجوهري. وقال ابن قدامة رحمه الله في (المغني)، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطرة، لأنها تجب بالفطر من رمضان. قال ابن قتيبة: وقيل لها: فطرة، لأن الفطرة: الخلقة، قال الله تعالى: {فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها} [سورة الروم: الآية 30]: أي جبلته التي جبل الناس عليها. هذا آخر كلامه. وقال الإمام ذو الفنون عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي في كتاب (ذيل الفصيح) وما يلحن فيه العامة في باب (ما يغير العامة لفظه بحرف أو حركة)، وهي صدقة الفطر، هذا كلام العرب. فأما الفطرة، فمولدة، والقياس لا يدفعه، لأنه كالغرفة والبغية لمقدار ما يؤخذ من الشيء. فهذا ما وجدته في اللفظة بعد بحث كثير، وسألت عنها شيخنا أبا عبد الله بن مالك فلم ينقل فيها شيئا، وذكر في (مثلته) أن الفطرة بضم الفاء: الواحدة من الكمأة. [النهاية 3/ 457، المعجم الوسيط 2/ 720، والمطلع ص 137].
- الابتداء والاختراع، وفطر الله الخلق: خلقهم وبدأهم. ويقال: (أنا فطرت الشيء): أي أول من ابتدأ، وهي حينئذ مأخوذة من الفطر. والحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». [البخاري- جنائز 92]: أي أنه يولد من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد، والحديث: «الفطرة عشر». [مسلم- طهارة 56]. قال ابن بطال الركبي: أصل الدين، وأصله الابتداء. والمعنى: آداب الدين عشر. والفطرة: صدقة الفطر، قال التبريزي: وقد جاءت في عبارات الشافعي رحمه الله وغيره، وهي صحيحة من طريق اللغة. راجع: [النهاية 3/ 457، والمعجم الوسيط 2/ 720، والمفردات ص 382، والنظم المستعذب 1/ 24، ونيل الأوطار 1/ 102، 103، 2/ 268، والتعريفات ص 147، والكليات ص 697، والمغرب ص 362].
[المصباح المنير (فطن) 477، والمطلع 397].
وفقأ عينه: شق حدقتها فخرج ما فيها وفقأ حب الرمان ونحوه: ضغطه وعصره. والفرق بينه وبين القلع: أن القلع نزع حدقة العين بعروقها، وقولهم: أبو حنيفة سوى بين الفقأ والقلع أرادوا التسوية حكما لا لغة. [النهاية 3/ 461، والمعجم الوسيط 2/ 722، والمغرب ص 363].
وقال الجوهري: نفاخات فوق الماء، والله تعالى أعلم. [المعجم الوسيط (فقع) 2/ 724، والمطلع، 374].
- الهمّ، والحرص، والجمع: فقور. قال الراغب: الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأول: وجود الحاجة الضرورية، وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا، بل عام للموجودات كلها وعلى هذا قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ} [سورة فاطر: الآية 15] الثاني: عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله تعالى: {لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا} إلى قوله تعالى: {مِنَ التَّعَفُّفِ} [سورة البقرة: الآية 273]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ} [سورة التوبة: الآية 60]. الثالث: فقر النفوس، وهو الشره المعنىّ بقوله- عليه الصلاة والسلام-: «كاد الفقر أن يكون كفرا». [كنز العمال 16682]، وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى النفس». [البخاري 8/ 118]، والمعنىّ بقولهم: من عدم القناعة لم يفده المال غنى. الرابع: الفقر إلى الله، المشار إليه في الحديث: «اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرنى بالاستغناء عنك». [الترغيب 2/ 615] وإياه عنى بقوله تعالى: {رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [سورة القصص: الآية 24]. وفقر مدقع: معناه: فقر شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب. وقال ابن الأعرابي: الدّقع: سوء احتمال الفقر، يقال: دقع الرجل- بالكسر-: أي لصق بالتراب ذلّا. [المفردات ص 383، والنظم المستعذب 1/ 253]. |